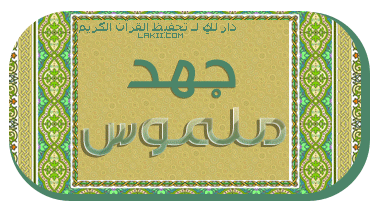بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى: "قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3].
وهذا يشمل الكمال من كل وجه.
وقال تعالى: }إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ{ [الإسراء: 9].
أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأخلاق والأعمال، والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية، والأحكام العمومية.
وقال تعالى: }وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ{ [المائدة: 50].
وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد، وأسلمها من الخلل والتناقض، ومن الشر والفساد إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة.
أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته، فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره مبلغًا لا يتمكن عاقل من الريب فيه.
ومن قال سوى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات.
وكذلك أحكامه السياسية، ونظمه الحكيمة والمالية مع أهله ومع غيرهم، فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة، والتي ستقع إلا باللجوء إليه، والاستظلال بظله الظليل، المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر، المانع من الشر، وليس مستمدًا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة، ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه، فإنها تنزيل العزيز العليم الحكيم العالم بأحوال العباد ظاهرها وباطنها، وما يصلحها وينفعها، وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأعلم بأمورهم، فشرع لهم شرعًا كاملاً مستقلاً في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع، صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خير.
ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكمًا حكمًا، في سياسة الحكم والمال، والحقوق والدماء، والحدود وجميع الروابط بين الخلق، تجدها هي الغاية، التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال.
وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم المقصورة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها، وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء منها.
ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور، فهذا من المصادفات التي لابد منها، وهو غني عنها في حال موافقتها أو مخالفتها.
فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثًا مستقلاً لا يربطه بغيره، أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها.
وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها، فذهب الدين ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا فيها عيشة هنيئة، ولا يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور.
أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب، ولا عنصر، ولا قطر ولا غيرها، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور، وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، والضارة فتترك .
هذه كلمة رائعة، وثمرة يانعة، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أخذتها من رياضه الناضرة، وحدائقه النيرة الزاهرة.
قال رحمه الله تعالى: "قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3].
وهذا يشمل الكمال من كل وجه.
وقال تعالى: }إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ{ [الإسراء: 9].
أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأخلاق والأعمال، والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية، والأحكام العمومية.
وقال تعالى: }وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ{ [المائدة: 50].
وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد، وأسلمها من الخلل والتناقض، ومن الشر والفساد إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة.
أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته، فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره مبلغًا لا يتمكن عاقل من الريب فيه.
ومن قال سوى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات.
وكذلك أحكامه السياسية، ونظمه الحكيمة والمالية مع أهله ومع غيرهم، فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة، والتي ستقع إلا باللجوء إليه، والاستظلال بظله الظليل، المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر، المانع من الشر، وليس مستمدًا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة، ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه، فإنها تنزيل العزيز العليم الحكيم العالم بأحوال العباد ظاهرها وباطنها، وما يصلحها وينفعها، وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأعلم بأمورهم، فشرع لهم شرعًا كاملاً مستقلاً في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع، صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خير.
ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكمًا حكمًا، في سياسة الحكم والمال، والحقوق والدماء، والحدود وجميع الروابط بين الخلق، تجدها هي الغاية، التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال.
وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم المقصورة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها، وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء منها.
ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور، فهذا من المصادفات التي لابد منها، وهو غني عنها في حال موافقتها أو مخالفتها.
فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثًا مستقلاً لا يربطه بغيره، أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها.
وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها، فذهب الدين ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا فيها عيشة هنيئة، ولا يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور.
أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب، ولا عنصر، ولا قطر ولا غيرها، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور، وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، والضارة فتترك .